https://dorar.net/arabia/58 ويُسمَّى أيضًا بجَمْعِ الألِفِ والتَّاءِ، ويكونُ بزيادةِ الألِفِ والتاءِ في آخِرِ
المفرَدِ، سواءٌ كان المفرَدُ مؤنثًا لفظيًّا ومعنويًّا، مِثلُ: فاطِمة فاطِمات، عائِشة عائِشات، أو معنويًّا فقط، مِثلُ: سُعاد سُعادات، هِنْد هِنْدات، أو كان مؤنثًا لفظيًّا فقط، مِثلُ: طَلْحة طَلَحات، أو كان مُذَكَّرًا، مِثلُ: سُرادِق سُرادِقات. ولا يدخُلُ فيه نحوُ: أبْيات، أمْوات، أصْوات، أقْوات، أوْقات؛ فإنَّ التاءَ فيها أصليَّةٌ؛ فمُفرداتُها: بَيْت، مَوْت، صَوْت، قُوت، وقْت. الفَرْعُ الأوَّلُ: ما يُجمَعُ جَمعَ المؤنَّثِ السَّالِم 1- ما في آخِرِه تاءُ تأنيثِ، سواءٌ كان عَلَمًا، أم اسمَ جِنسٍ، أم غيرَ ذلك، مُذَكَّرًا أم مؤنثًا. تقولُ: مُعاوِيَة: مُعاوِيَات، طلْحة: طَلَحات، وَرَقة: وَرَقات، وكذلك: بِنْت وأُخْت. تقولُ: بنات، أَخَوات؛ فإنَّ التاءَ فيهما زائدةٌ للتأنيثِ، وكذلك تاءُ التأنيثِ للمُبالَغةِ. تقولُ: رجلٌ علَّامة ورِجالٌ علَّامات. ولا يُجمَعُ مِثلُ: امْرَأة، شَفَة، شاة، فُلانة، فُلَة، أَمَة. 2- العَلَمُ المؤَنَّثُ: سواءٌ زيدت فيه تاءُ التأنيثِ أم لا. تقولُ: زَيْنَبَات، هِنْدات، عائِشات، فاطِمات. 3- صِفةُ ما لا يَعقِلُ مُذَكَّرًا. تقولُ: جبلٌ راسٍ ويومٌ معلومٌ، وجِبالٌ راسياتٌ، وأيامٌ مَعلوماتٌ. بخلافِ صفةِ المُذَكَّرِ العاقِلِ؛ فلا يقالُ: رجلٌ عالِمٌ ورِجالٌ عالِمات، كذلك صِفةُ المؤنَّثِ؛ فلا يقالُ: امرأةٌ حائِضٌ ونِساءٌ حائِضاتٌ. 4- مُصغَّرُ ما لا يَعقِلُ مُذَكَّرًا، نَحْوُ: دُرَيْهِم ودُنَيْنِير، تقول: دُرَيْهِمات، دُنَيْنِيرات. 5- اسمُ الجِنسِ المؤنَّثُ وفيه ألِفُ التأنيثِ، مِثلُ: بَهْمَى بَهْمَيَات، صَحْراء صَحْراوات. 6- الصِّفةُ المؤنَّثةُ وفيها ألفُ التأنيثِ، مِثلُ: امرأة حُبلى ونِساءٌ حُبْلَيات، وحُلَّةٌ سِيَراءُ وحُلَلٌ سِيرَاوَات. إذا كانت الصِّفةُ على وَزنِ فَعْلَى التي مُذَكَّرُها فَعْلانُ، مِثلُ سَكْران سَكْرى، أو كانت على وزن فَعْلاء ومُذَكَّرُها أفْعَل، فلا تُجمَعُ الصِّفةُ جمعَ مُؤَنَّثٍ سالمًا، كما أنَّ فَعْلان وأفعَلَ لا يُجمَعان جمعَ مُذَكَّرٍ سالمًا كما ذكَرْنا. إلا أنَّه إن نُقِلَت تلك الأوزانُ إلى الأسماءِ بأن تسمَّت امرأةٌ بـ "حَمْراء، أو ظَمْأَى، أو سَكْرَى"، ونحو ذلك؛ فإنها تُجمَعُ على: حَمْرَاوات وظَمْآوات وسَكْراوات. أمَّا إن كانت فَعْلاءُ صِفةَ مُؤَنَّثٍ لا مُذَكَّرَ لها؛ كعَذْراء وعَجْزاء وشَوْكاء ونحوِ ذلك، فقد أجاز ابنُ مالكٍ أن تجمَعَ جَمعَ مُؤنَّثٍ سالمًا. أمَّا ما ورد مجموعًا جمعَ مُؤَنَّثٍ سالمًا على غيرِ تلك الشُّروطِ، فسَماعًا لا قياسًا، نَحْوُ: سماءٍ سماواتٍ، أَرْض أَرضات، عِير عِيرات، ثيِّب ثيِّبات، حُسام حُسامات... . انظر أيضا: تمهيدٌ: جمعُ المؤنَّثِ السَّالِم. الفَرْعُ الثاني: إعرابُ جمعِ المُؤَنَّث السَّاِلم. الفَرْعُ الثالثُ: المُلحَقُ بجَمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ. (1) ينظر: ((ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب)) لأبي حيان الأندلسي (2/ 588)، ((تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد)) لناظر الجيش (1/ 421). الفَرْعُ الثاني: إعرابُ جمعِ المُؤَنَّث السَّاِلم يُعرَبُ جمعُ المؤنَّثِ السَّالمُ بالحركاتِ، إلَّا أنَّه يُرفَعُ بالضَّمَةِ، ويُنصَبُ ويُجَرُّ بالكَسْرةِ؛ فالكَسْرةُ في نَصْبِه علامةٌ فَرعيَّةٌ لا أصليَّةٌ. تقول: هؤلاء النِّسوةُ مُسلِماتٌ. هؤلاء: اسمُ إشارةٍ مَبنيٌّ على الكَسرِ في محَلِّ رَفعٍ مُبتدَأٌ. النِّسوةُ: بَدَلٌ مرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ. مُسلِماتٌ: خَبَرٌ مرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ. وقال تعالى: لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [آل عمران: 15] ، وقال سُبحانَه: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ [آل عمران: 133] . وتقولُ في الجَرِّ: هذه مدْرسةُ الفَتَياتِ. هذه: اسمُ إشارةٍ مَبنيٌّ على الكَسرِ في محَلِّ رَفعٍ مُبتدَأٌ. مَدْرَسةُ: خَبَرٌ مرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ. الفَتَياتِ: مُضافٌ إليه مجرورٌ، وعَلامةُ جَرِّه الكَسْرةُ الظَّاهِرةُ. ومنه قَولُه تعالى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [النساء: 131] . وفي النَّصبِ تقولُ: خلَق اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أيَّامٍ. خلق: فِعلٌ ماضٍ مَبْنيٌّ على الفَتحِ. اللهُ: اسمُ الجلالةِ فاعِلٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ. السَّمَواتِ: مَفعولٌ به مَنصوبٌ، وعَلامةُ نَصبِه الكَسرةُ؛ لأنَّه جمعُ مُؤنَّثٍ سالمٌ. ومنه قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ [النساء: 57] ، وقَولُه تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 35] ، وقَولُه تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا [التحريم: 5] . انظر أيضا: تمهيدٌ: جمعُ المؤنَّثِ السَّالِم. الفَرْعُ الأوَّلُ: ما يُجمَعُ جَمعَ المؤنَّثِ السَّالِم. الفَرْعُ الثالثُ: المُلحَقُ بجَمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ. الفَرْعُ الثالثُ: المُلحَقُ بجَمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ أُلِحقَت طائفةٌ من الكَلِماتِ التي لا مُفرَدَ لها مِن لَفْظِها بجمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ، فأُعرِبَت إعرابَه، فتُرفَع بالضَّمَّةِ، وتُنصَبُ بالكَسرةِ بدلًا من الفَتحةِ، وتُجَرُّ بالكَسرةِ. وهذه الكَلِماتُ هي: 1- أُولَات: وهي بمعنى ذواتٍ أو صاحباتٍ، مُؤَنَّث (أولو)، تقولُ: هُنَّ أولاتُ علمٍ، رأيتُ النِّسوةَ أولاتِ العِلمِ، ذَهَبْتُ إلى النِّسوةِ أولاتِ العِلمِ؛ فكَلِمةُ "أُولات" الأولى: خَبَرٌ مرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ، والثانيةُ: نَعتٌ منصوبٌ، وعَلامةُ نَصبِه الكسرةُ نيابةً عن الفتحةِ؛ لأنَّه مُلحَقٌ بجَمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ، والثالثةُ: نعتٌ مجرورٌ، وعَلامةُ جَرِّه الكَسْرةُ. وفي القُرآنِ مَرفوعةٌ بالضَّمَّةِ: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4] ، ومنصوبةٌ بالكَسرةِ: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6] . 2- ما سُمِّي بجَمْعِ المؤنَّثِ السَّالمِ، مِثلُ: أَذْرِعَات وعَرَفَات، وكذا غيرُها من الجُموعِ؛ فلو تسمَّت امرأةٌ بسَعاداتٍ أو زَيْنباتٍ، فإنَّها تلتَحِقُ بجَمعِ المؤنَّثِ السَّالمِ وإن لم تكُنْ جَمعًا، فتُرفَعُ بالضَّمَّةِ، وتُجَرُّ بالكَسرةِ، وتُنصَبُ بالكَسرةِ نيابةً عن الفتحةِ، فتقولُ: هذه عَرَفاتٌ، وصَعِدْتُ عَرَفاتٍ، ونزَلْتُ من عَرَفاتٍ. وهذا الإعرابُ هو الأكثَرُ، وقد جاء في القرآنِ هكذا مَصروفًا، قال تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ [البقرة: 198] . وذهب بعضُهم إلى إعرابِ ذلك النَّوعِ إعرابَ الممنوعِ مِنَ الصَّرفِ؛ لأنَّه مُؤَنَّثٌ، فيقولُ: هذه عَرَفاتُ، صَعِدْتُ عَرَفاتَ، نزلتُ مِن عَرَفاتَ؛ فيرفَعُه بالضَّمَّةِ بغيرِ تنوينٍ، وينصِبُه ويجُرُّه بالفَتحةِ. وبعضُهم يُعرِبُه إعرابَ جمعِ المؤَنَّثِ لكِنْ بلا تنوينٍ؛ فيرفَعُه بضَمَّةٍ واحِدةٍ، وينصِبُه ويَجُرُّه بكَسرةٍ واحِدةٍ؛ يقولُ: هذه عرفاتُ، صَعِدْتُ عَرَفاتِ، نزَلْتُ من عَرَفاتِ. وقد رُوِيَ بَيتُ امرئِ القَيسِ على الثَّلاثةِ الأوجُهِ: تَنَوَّرْتُها من أَذْرِعاتٍ وأَهْلُها بِيَثْرِبَ أَدْنَى دارِها نَظَرٌ عالِي فجاءت: أَذْرِعاتَ، وأذرعاتٍ، وأَذْرِعاتِ . انظر أيضا: تمهيدٌ: جمعُ المؤنَّثِ السَّالِم. الفَرْعُ الأوَّلُ: ما يُجمَعُ جَمعَ المؤنَّثِ السَّالِم. الفَرْعُ الثاني: إعرابُ جمعِ المُؤَنَّث السَّاِلم. (1) يُنظَر: ((أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)) لابن هشام (1/ 87)، ((شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو)) لخالد الأزهري (1/ 83). تمهيدٌ: أقسامُ الاسمِ مِن حيثُ التنكيرُ والتعريفُ ينقَسِمُ الاسمُ مِن حيثُ التنكيرُ والتعريفُ إلى قِسْمَينِ: النَّكِرةُ والمعرِفةُ. والنَّكِرةُ هي الأصلُ في الأسماءِ، والمعرِفةُ فرْعٌ عليها؛ لأنَّ التعريفَ يَحتاجُ إلى علامةٍ، والتنكيرَ لا يحتاجُ، وما يحتاجُ إلى علامةٍ فرعٌ على ما لا يحتاجُ إلى علامةٍ. انظر أيضا: المَبْحَثُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّكِرةِ. المَبْحَثُ الثَّاني: تعريفُ المَعرِفة. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أقسامُ المَعرِفةِ. المَبْحَثُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّكِرةِ النَّكِرةُ هو: الاسمُ الشَّائعُ في جِنسِه، الذي وُضِعَ لا ليَخُصَّ واحِدًا بعينِه من بين أفرادِ جِنْسِه، بل يَصلُحُ أن يُطلَقَ على كُلِّ واحدٍ منهم؛ فقَولُك: (رَجُل) يَشمَلُ كُلَّ الذُّكورِ البالغينَ من بني آدَمَ. وهو كلُّ اسمٍ يَقبَلُ دُخولَ الألِفِ واللامِ المؤثِّرةِ للتعريفِ عليه، أو يقَعُ مَوقِعَ ما يَقبَلُ الألِفَ واللَّامَ. مِثالُ ما يَقبَلُ دُخولَ الألِفِ واللَّامِ: (رَجُل، وفَرَس، ودار، وكِتاب)؛ فتقولُ: (الرَّجُل، الفَرَس، الدَّار، الكِتاب). ومثالُ ما يقَعُ مَوقِعَ ما يقبَلُ الألِفَ واللَّامَ: (ذي) في قَولِك: (مررتُ برجلٍ ذي مالٍ)؛ فإنَّها واقعةٌ موقعَ (صاحِب)، وهو يقبَلُ دُخولَ الألفِ واللامِ، و(مَن) في قولك: (ومررت بمَن أُحِبُّ)؛ فإنها واقِعةٌ مَوقِعَ (إنسان)، و(ما) في قَولِك: (مَرَرتُ بما أُحِبُّ)؛ فإنَّها واقعةٌ مَوقِعَ (شَيءٍ). وقولُنا: (المؤثِّرة للتعريفِ عليه) احترازٌ ممَّا يقبَلُ (أل) ولا تُؤثِّر فيه التعريفَ، كـ(عَبَّاس)؛ فإنَّ (أل) تدخُلُ عليه، فتقولُ: (العَبَّاس) لكِنَّها لا تُؤثِّرُ فيه التعريفَ؛ لأنَّه مَعرِفةٌ قبل دخولها عليه . انظر أيضا: تمهيدٌ: أقسامُ الاسمِ مِن حيثُ التنكيرُ والتعريفُ. المَبْحَثُ الثَّاني: تعريفُ المَعرِفة. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أقسامُ المَعرِفةِ. (1) يُنظَر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن عقيل (1/86). المَبْحَثُ الثَّاني: تعريفُ المَعرِفة المَعرِفةُ: هي ما سِوى النَّكرةِ، وهو اللَّفظُ الذي يدُلُّ على مُعيَّنٍ. مِثْلُ: مُحَمَّد، زَيْد، سُعاد، فاطِمة، الشَّمْس، القَمَر. انظر أيضا: تمهيدٌ: أقسامُ الاسمِ مِن حيثُ التنكيرُ والتعريفُ. المَبْحَثُ الأوَّلُ: تعريفُ النَّكِرةِ. المَبْحَثُ الثَّالِثُ: أقسامُ المَعرِفةِ.
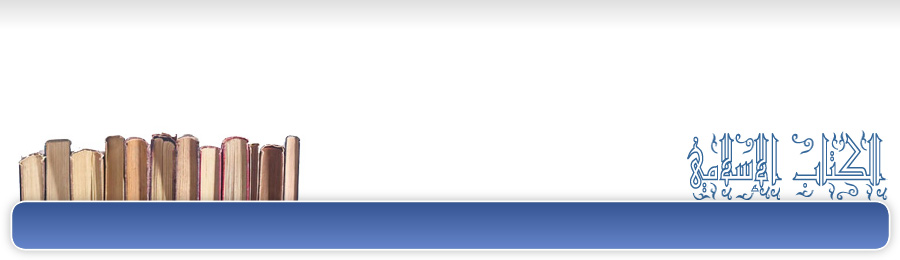
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق